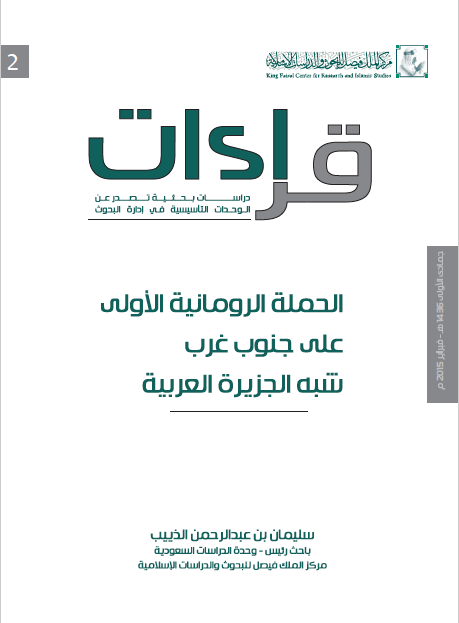قراءات
سليمان بن عبدالرحمن الذييب
هذا العمل دراسة علمية لعدد من النقوش الثمودية التي صنفتها بالدينية الدعوية، والتي رُصدت في عدد من المواقع في منطقة حائل. وسعيتُ أن يكون هدف الدراسة إلقاء الضوء على إحدى الظواهر الاجتماعية التي مارسها أهالي حائل «الثموديون ،» وهي ظاهرة الدعاء والتوسل للآلهة )المعبودات(. ولعلي أشير هنا مرة أخرى إلى أن هذا العمل جزء من مشروع ضخم أسعى فيه إلى نشر ورصد كل الكتابات الثمودية في المملكة العربية السعودية، والتي فاقت الآلاف، منتشرة في كل أنحاء وطننا الكبير. ونقوش منطقة حائل المعروفة حاليًا تعود إلى الفترة التاريخية الواقعة بين القرنين السادس إلى الأول قبل الميلاد؛ وبلغ المُسجل منها حتى يومنا الحاضر »1222« نقشًا ثموديًا، جاءت من أربعة وثلاثين موقعًا، في جهات مختلفة من منطقة حائل العريقة بتاريخها وآثارها.
وقد احتوى هذا العمل على مقدمة مختصرة عن مضامين هذه ا�
إقرأ المزيد
سليمان بن عبدالرحمن الذييب
يعود استيطان منطقة حائل، الواقعة في شمالي المملكة العربية السعودية، إلى العصور الحجرية، وقد ساعدت بيئتها المناسبة، إلى حدٍّ كبير، على جذب الإنسان إليها وتفضيلها على غيرها. ومما تركه لنا إنسان حائل تلك الكتابات المعروفة تجاوزًا ب ((الثمودية)),وهي كتابات يُستحسن أن نسميها أيضًا: الكتابات الشعبية، فعددُها ومناطق انتشارها ومضامينها يجعلها كذلك. فهي تزيد على الآلاف، وانتشارها يغطي، بشكل واضح،جميع مناطق شبه الجزيرة العربية من شمالها إلى جنوبها مرورًا بوسطها، ومن غربها إلى شرقها أيضًا، وإن كان محدودًا - حتى الآن - في الأخيرة. أما مضامينها فتعكس واقع الإنسان دون رتوش أو تجميل، ويمكننا أن نسميها دون تردُّد: تغريدات «تويتر » ذلك الزمن؛ فهي تُعبِّر عن آماله وطموحاته ودعواته وخلجاته وأدقّ تفاصيل حياته؛ كما أنها قصيرة ومباشرة. كلُّ ذلك بخط وحيد انتشر في
إقرأ المزيد
د. وان لي
مقالٌ للدكتور وان لي: (أول سجل سفر صيني في العالم العربي - الاتصالات التجارية والدبلوماسية خلال العصر الذهبي للإسلام) نشره مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ضمن سلسلة قراءات في عدد (ربيع الأول 1438هـ/ ديسمبر 2016م - يناير 2017م).
يتألف المقال من ثلاثة مواضيع رئيسة -جميعها ترجمات وتفسيرات من الكتب التاريخية الصينية الرسمية التي سجلت الأحداث خلال عهد أسرة تانغ (618 - 917م)-: الأول (سجل السفر)، وهو عن دو هوان جينغشينغي، أول صيني سافر وتجول في العالم العربي. وجاء الموضوع الثاني متناولًا (جيان دان قوانغتشو تونغاي يداو - الطريق البحري إلى البلدان الغريبة من قوانغتشو). ويتناول الثالث الزيارات الرسمية العربية لداشي إلى محكمة تانغ الصينية، التي تم تسجيلها في سيفو يوانجوي (Archival Palace as Great Oracle Tortoise).
كل هذه المواضيع توفر للقراء المعاصرين قصصًا حقيقية عن العلاقات والاتصالات بين العالم العربي والصين عبر ال�
إقرأ المزيد
وان لي
يستكشف هذا المقال هجرة المسلمين الأولى إلى الصين خلال حقبة سلالات تانغ وسونج. تثبت خلفيات هذه الهجرة، إلى جانب مختلف المسميات الصينية التي أٌطلقت على المسلمين ومجتمعاتهم، وقادتهم تثبت شكلا من أشكال الاعتراف القديم من قبل الشعب الصيني من المسلمين. وتركز هذه المقالة على دراسات مهام القادة المسلمين ومسؤولياتهم ومواجهاتهم مع النظام الشرعي الصيني؛ إذ يتعيّن على أي مجتمع للتكيّف مع مجتمع جديد آخر، أن يخضع للتثقيف. وأخيرا، تم تحسين منظومة القادة المسلمين من قبل سلالة منغول يوان التي ورثت العرش، وأصبح المجتمع المسلم منذ ذلك الوقت من ضمن النسيج الاجتماعي التقليدي الراسخ المتمثل في شعب الهوي والممتد حتى اليوم.
إقرأ المزيد
تتناول هذه الدراسة التعليم في المدينة المنورة في القرن السابع عشر الميلادي من خلال حياة وحلقة أحمد بن محمد القُشاشي، وهو أحد أكثر علماء الصوفية تأثيراً في منطقة الحجاز العثمانية في القرن السابع عشر الميلادي، وكان له دور رائد لا يمكن تجاهله في سبيل نشر المعرفة بلغ مداه أمكنةً بعيدةً تصل إلى إندونيسيا، وقد سمع مشاهير المتصوّفة وعلماء الحديث في وقت متأخّر، ممّن يُشير إليهم بعض المؤرّخين المعاصرين بأنهم من أنصار (النهضة الإسلامية والإصلاح)، روايات الحديث من طريق الكوراني عن سلسلة من العلماء من مدرسة القشاشي. وتحاول هذه الدراسة تقديم رؤى حول البناء الفكري لهذا العالم المؤثّر.
إقرأ المزيد
تتناول هذه الدراسة جانباً مهماً من جوانب الحياة اليومية في الحضارة النبطية، وهو
موضوع استهلاك وإنتاج الطعام والشراب، وهو من المواضيع التي لم تُطرح بصورةٍ
شموليةٍ من قِبل الباحثين من قَبل؛ وسبب ذلك قلة المادة العلمية المتوفرة التي كانت
حتى فترة متأخرة من ماضينا القريب مقتصرةً على إشارات قليلة متناثرة في ثنايا كتابي
ديودورس الصقلي وسترابو.
ما تزال معلوماتنا عن الكثير من الجوانب الحضارية والثقافية النبطية محدودة المصادر،
ونعتمد بشكل أساسي لفهم هذه الجوانب على المادة الأثرية المكتشفة واستقرائها
واستنطاقها، وتحليل ما ورد من إشاراتٍ مرتبطةٍ بها في المصادر التاريخية التي كُتبت
في مرحلة معاصرة لوجودهم، ويتوفر لنا ثلاثة مصادر فقط نستقي منه�
إقرأ المزيد
تُعَدّ الكتابات المعروفة اصطلاحاً بالصفوية (الصفائية) من أبرز ما خلّفه لنا إنسان شبه
الجزيرة العربية في المدة الواقعة بين القرنين الثاني قبل الميلاد والرابع الميلادي، ومع أن
كمية النقوش الصفائية قليلة في بلادنا الغالية، مقارنةً بتلك التي عاصرتها زمنياً، وهي
الكتابات الثمودية، لكنها اشتركت معها في أنهما كانتا بحقٍّ مرآةً للمجتمع العربي القديم
ببساطته وسهولته وصدقه؛ فهي نقوش تخلو من المبالغات والتضخيم الذي نجده في
الكتابات العربية والسامية الأخرى.
عُثر على النقوش الصفائية التي تضمّها هذه الدراسة في شمال المملكة العربية السعودية
وهي مثل بقية النقوش الأخرى تضيف إلى معلوماتنا عدداً من النواحي الاجتماعية والدينية
لذلك المجتمع الأ
إقرأ المزيد
مصطلح "الهويزو Huizu" هو المسمى الرسمي للهوي هويزو (جماعة الهوي هوي العرقية) في الصين المعاصرة، وهو مشتقٌّ من منظومة نُسخ بينيين الصينية الأصلية المدوَّنة، والمستمدة من الكلمات المنطوقة من حرفين منفصلين في اللغة الصينية، هما: "هوي"، و"تشو"، ولكلٍّ منهما معنًى مستقلٌّ، ثم أصبح لهما معنًى جديدٌ عندما تم دمجهما ليُكوِّنا معاً كلمة "الهويزو" (على غرار النمط القياسي لتشكيل الكلمة الصينية). والمقطع السابق هو اختصار لـ"هوي-هوي"، وهو مصطلح يشير إلى جماعة عرقية ظهرت في منطقة "تشيو Xiyu" (المناطق الغربية الموجودة على الجانب الآخر من إقليم شينجيانغ الحالي) منذ أواسط القرن السابع عشر الميلادي. وكان هؤلاء الناس من المهاجرين الأوائل من المناطق ذات الأغلبية المسلمة في آسيا الوسطى الذين استقروا داخل الأراضي الصينية. وقد ظهر هذا المقطع الأخير في أوائل عهد سلالة شانغ (القرن 16
إقرأ المزيد

دراسات فريدريك وينيت لنقوش ثمودية من منطقة حائل
شوال ١٤٣٥هـ / أغسطس ٢٠١٤م
ملخص
يحتوى العمل على تعريف بالباحث الكندي وينيت وجهوده في دراسة النقوش العربية القديمة، وأربعة عناوين، أولها كان دراسة لنقوش الاشتياق التي تضمنت الأفعال:ت ش و ق أي “اشتاق”، م ت و ق أي “متوق”، و د د أي “حَبَّ، وَدَّ” و د أي “حبَّ، ودَّ”؛ وقد بلغت (20) نقشًا. أما الثاني فاشتمل على دراسة النقوش الاجتماعية، التي بلغت (52) نقشًا؛ وقد عكست هذه النقوش صورة عن المجتمع وأحواله آنذاك، مثل: المهن التي مارسها هؤلاء أو الأمراض التي انتشرت بينهم أو العادات الاجتماعية المختلفة، مثل: الزواج أو الطلاق. في حين كان نصيب نقوش الحزن العنوان الثالث، ونعني بها النقوش التي ترد فيها الأفعال الدالة على الحُزْن مثل: ر ن ت أي “صرخ، رثى، العويل”، و ج م أي “وَجَمَ”، ن ا ح أي “نَاحَ”. والطريف أن الثمو
إقرأ المزيد